منبـ ... نار
خواطر سريعة … على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغة العربيّة
نشرت
قبل سنة واحدةفي
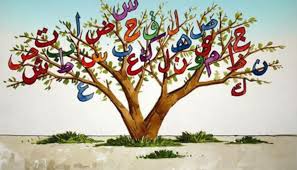
هل ما زال يفيد العربيّة اليوم استرجاع مجدها في الشعر والخطابة وهل تضيف إليها غنائيّة المتعصّبين لنقائها الفصيح ولدورها في تدوين المقدّس وتفسيره وتفسير التفاسير المتتابعة؟

- هل ما زال يفيدها التأكيد على ما حمله فكرها وفلسفتها وطبّها وجبرها من إضافة كونيّة إلى الغرب في العصر الوسيط؟ هل من فائدة من كلّ ذلك ونحن لا نكاد نشارك في إنتاج المعرفة والعلم الحديثين؟
- أم – وعلى نقيض ذلك – هل يجدر بنا أن نلتفت إلى فريق آخر لا يتقن غير النحيب على حالها وعلى تخلفها وعجزها الراهن عن مواكبة العلوم والتكنولوجيا وعلى مواكبة الثورة التي أحدثتها الرقمنة وهزّت بها العالم فنسلّم كما يسلّمون بكونها لغة “ميتة” يستحيل إحياء قدرتها على استيعاب منجزات الحداثة؟
- هل نواصل دعم قوالب الصراع والتنافر بينها وبين اللهجات العاميّة أم نبحث بمساع إبداعيّة متنوّعة عن حيويّة التفاعل بينهما كما بادر بذلك مبدعون عرب راسخون في الخلق وهم كثر؟
ليس في ثبات المواقف الثلاثة السّابقة دليل واحد عميق على حب العربيّة….
- لم تعد العربيّة – ولم تكن يوما – في حاجة إلى المزايدين من أهل الصراع السّياسوي ومن مختلقي الصِّراع الهوويّ… بل هم أكبر عبء عليها … هم يستعملونها حطبا و”كنتولا” فيلوكونها في خطابات رديئة تافهة عاجزين في أغلبهم حتّى على مجرّد النطق السّليم لحرفها….هم أعداء حقيقيّون لبهجتها الدّفينة ولدقائق معانيها وأجراس موسيقاها الأبديّة…
العربيّة تنادي كلّ صباح وتحنو كلّ مساء على من يلتهم أدبها وفكرها ..من يقاتل لنشر الكتاب الناطق بها ….من يبدع بها وفيها على هواه فتبادله وجدا بعشق وتفتح له مسارب وثنايا …تعمّق أحلامه وتعطي لكوابيسه معنى فتقلبها كشوفا…
- آخر ما تحتاجه العربيّة اصطناع الاستماتة في الدّفاع عن عبقريّتها الرّاقدة في كتب الماضي وحِكَم الغابرين …هي في حاجة جامحة إلى من يدفع بها إلى خطر التجربة والمراس والمخاتلة… إلى مزالق التفاعل مع المتغيّر والهارب …إلى مزيد من المغامرة الشيّقة الوعرة …
من يخاف عليها من التشويه …من يريد المحافظة عليها مصونا نقيّة فخير له وخاصّة لها أن يدعها “تنام على أنوثتها كاملة”….فيريحها ويريح محبّيها أكثر…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أستاذ أدب عربي، مستشار عام في الإعلام و التوجيه المدرسي و الجامعي
تصفح أيضا
منبـ ... نار
تكريما لروحك يا “جاد”… أعلِنُك رئيسا رمزيا
نشرت
قبل أسبوع واحدفي
10 أبريل 2024من قبل
التحرير La Rédaction
توفيق العيادي:
كان جاد نصيرا للمرضى والعجّز والفقراء ولم يطلب يوْما نصرتهم لكسْب أو منصب أو مغنمٍ له، وقد هبّ الناس لتوديعه لأنهم أحسّوا فعلا بعظيم خسارتهم في موته.

لم أعرف جاد الهنشيري إلا عن طريق الصدفة ومن خلال برامج تلفزية دُعِيَ لها ضيفا كممثل للأطباء الشبان، ولم ألتقه مطلقا، فقط استمعت إليه أكثر من مرّة وهو يُلقي بهمّه الذي هو همّ الفقراء على مسامع التونسيات والتونسيين، ويقطفُ من روحه أمَلاً يُرسِله لهم جميعا درْءً لأحزانهم التي فاقت كل معايير القيس وأدوات الأكيال والأوزان، وثـقُـل عليْهم حِمْلُ الهموم التي ناءتْ بها الأعناق، والمرارة على محيّا جادٍ بادية لا تُخطئها العين ويتدفّق الصدّق من بين موجات صوته المَغْصوص كَغُصَصِ كل الشباب الحالم على هذه الأرض، ولا تخلو غصّة جاد من معنىً يؤطّره مبدأ أساسيّ يشُدّ الحلم وينير الطريق ويُحفّز على المسير وتجشّم الصّعاب، مبدأ فحواه أنه : ” بمقدورنا أن نكون أفضل .. يجب أن نكون أفضل”، رغم الاستهجان والاعتراف بحجم الفساد الذي نخر معظم القطاعات والفئات في هذا الوطن.
لكَمْ نحن في حاجة ماسّة إلى شابّ جادٍّ كما “جاد” يتوهّج عزما وحبا وصدقا، ولسنا في حاجة إلى “عـتْـڤـة” قديمة كما بعض من فاق السبعين وغنِم من العهديْن ويريد اليوْم أن يستزيد … مات “جاد” رحمه الله وأغدق على أهله وصحبه الكثير من الصبر والسّلوى. لكنّ القِيَم التي حملها جادّ وحلُم بها وحمّلها لمنْ بعْدِه من الصّحْب والرّفقة، لا تزال قائمة، فأمثال جاد من الشباب الأوفياء والخلّص للوطن بكل مكوّناته سيّما البسطاء منهم، موجودون بالعشرات، بل بالآلاف وفي كل ربوعه، وما على الوطن إلاّ أن يَجِدّ في طلبهم والبحث عنهم وأن يُصدّرهم مواقع الريادة والقرار ،وإن حَجَبَهُمْ عنّا تعفّـفهم،
إذا كنا نريد فعلا المضيّ في الطريق المفضي إلى المشروع الحرّ وجبَ أن نغادر خصومات كسب العواطف واِستمالة الأهواء ونعراتِ التحامق، ونمضي في تسابق نحو كسب العقول وتهذيبها وتنظيفها من كل الشوائب العالقة بها لعهود .. ولذلك أقول للمشتغلين بالسياسة والمتكالبين على استدرار الشعب لتدبير شأنه العام والاستحكام برقابه، إن السياسيّ الناجح هو الذي يُبينُ للناس ما فيه من فضائل وما هو عليه من إقتدار وليس نجاح السياسي رهين عرض نقائص الخصم والتشنيع عليه وتعظيم مساوئه وإن كان له فيها نفع.
ونذكّر السياسي أيضا أن الجدارة بالحكم لا تتوقّف عند حدّ الفوز بالتفويض من الإرادة الشعبيّة عامة كانت أو مطلقة، كما أن النوايا الطيّبة لا تكفي لمزاولة السلطة، بل يبقى صاحب السلطة في حاجة إلى تأكيد شرعيّته بحسن إدارة الحكم الذي ينعكس وجوبا على أحوال الناس، وهذا لا يتمّ لهم بواحدٍ بل بكثيرين ومن أمثال “جاد الهنشيري” تضحية وصدقا ومروءة …
رحل جاد وبقي أثره فينا، وتكريما لروحك يا “جاد” واِنحيازا لكلّ قيَمِ الجدارة والصدق والإنسانيّة والجدوى، والتي مثّلتها باقتدار، أعْـلِنُـكَ “رئيسا” رمزيّا وشرفيّا بالغياب لهذا الوطن الحزين … ليطمئن السياسيون، فـ”جاد” لن ينهض من غيبته الأبديّة، وستكون قيمه تقضّ مضاجعكم كلّما اجتمعت لشخصٍ خشية أن يُبعثر حسابات الرّبح مِمّا تمِزّون من دماء الوطن.

منبـ ... نار
هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي و تبحث عن مصادر بديلة؟ (2)
نشرت
قبل 3 أسابيعفي
29 مارس 2024من قبل
التحرير La Rédaction
عرفت تونس أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة بعيد ثورة 14 جانفي، وتتالت هذه الأزمات و امتدت آثارها السلبية الى اليوم رغم القطع مع المنظومة البائدة إثر حراك 25 جويلية.

إلا أن الانتهازيين و أصحاب المصالح والسابحين عكس تيار النهوض بالبلاد عطلوا عملية الإصلاح وعملوا على إفشالها وذلك بكل السبل، فبقيت تونس رهينة الديون المتراكمة والمجَدْولة، وسياسات الجذب الى الخلف كالتهريب والمضاربة وتبييض الأموال. غير أن الإرادة الصادقة، والإيمان القوي بضرورة تغيير حال البلاد إلى الأفضل جعلها لا تنحني إلى الابتزازات، ولا تخضع للشروط.
فرغم توصلها في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر تحت طائلة الشروط القاسية كرفع الدعم، خفض الأجور و بيع مؤسسات عامة متعثرة. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم وضع تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة من قبل هذا الصندوق، الأمر الذي صعب على بلادنا النفاذ الى الأسواق المالية العالمية.
وتفاديا للوقوع في صدمات اجتماعية واقتصادية، نجحت تونس بفضل تطور صادراتها، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتنويع شركائها التجاريين إضافة إلى اعتمادها على الاقتراض الداخلي، والاكتتابات المتتالية لدى بورصة تونس، وانخراط التونسيين في هذه العملية، وهو نوع من الوعي الوطني والدفاع عن حرمة تونس، و نتيجة لذلك تحقق توازن مالي لدى البلاد هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أعطت درسا لصندوق النقد الدولي بإمكانية التخلي عن خدماته عند الاقتضاء وخاصة عند المساس بأمنها القومي.
ورغم أن الفضاء الطبيعي لتونس هو الفضاء الإفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي المبادلات التجارية معه، إلا أنها عبرت عن انفتاحها على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في اشارة إلى مجموعة “البريكس”.
إن تونس مازالت منفتحة على الحوار مع صندوق النقد الدولي لكن دون إملاءات أو شروط تهدد السلم الاجتماعي. وإن تعذر ذلك فتونس مستعدة للانضمام الى بريكس للحصول على التمويلات اللازمة.

منبـ ... نار
هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي وتبحث عن مصادر بديلة؟
نشرت
قبل شهر واحدفي
16 مارس 2024من قبل
التحرير La Rédactionرغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت لأسباب معلنة وأخرى مجهولة، ما تزال تونس صامدة ورافضة لشروط صندوق النقد الدولي، موفية بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها إذ بلغت نسبة خلاص الديون إلى موفى شهر جويلية 2023 48%. فهل يؤشر هذا على إرادة من تونس للتخلص من هيمنة القطب الواحد وانفتاحها في تعاملاتها المالية و التجارية على أسواق جديدة؟

يتأهب العالم لإرساء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب بعد إزاحة نظام القطب الواحد والمتمثل في الهيمنة الامريكية المطلقة على جميع القطاعات ومعظم الدول وحليفها الاستراتيجي الاتحاد الاوروبي. وقد ساهمت الحرب الروسية- الاوكرانية الى حد بعيد في ظهور قطب اقتصادي وعسكري جديد، خاصة بعد بداية التقارب الروسي-الصيني والمضي قدما في تركيز “بركس” بنك التنمية الجديد والمكون من أسماء الدول الأكثر نموا اقتصاديا بالعالم وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا.
وقد اتفق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية الآنية، وتتالت اللقاءات على المستوى الأعلى لزعماء دول البركس BRICS منذ سنة 2008 قصد مزيد التشاور والتنسيق، وتواصلت الى سنة 2023 مع العلم ان مساحة هذه الدول تمثل 40% من اليابسة وعدد سكانها يقارب 40% من سكان العالم.
و بالعودة إلى تونس و رغم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية و شاملة، والتزام هذا الأخير بمساعدتها على بناء نموذج تنمية مستدام و غير إقصائي، و دعم ميزانيتها بمبلغ سيمنح كاملا بعنوان سنة 2023. وامام انفتاح روسيا على رفع نسق التبادل التجاري بينها ودول المغرب العربي، واعتماد مصر كبوابة لتنمية هذا التبادل مع اعتماد العملات المحلية بديلا عن الدولار، وإعراب تونس عن استيراد الحبوب من روسيا باسعار تفاضلية والتزام هذه الأخيرة بتسهيل المعاملات وتنشيطها هذا من ناحية، و من ناحية أخرى وبحصول الجمهورية التونسية على قرض ميسر بقيمة 1200 مليون دينار ومنحة بقيمة 300 مليون دينار من السعودية وسعيها إلى رفع قيمة صادراتها وفي مقدمتها مادة الفوسفات. هل تتخلى عن التعامل مع صندوق النقد الدولي في انتظار ارساء بركس وبداية التعامل معه كشريك اقتصادي ومالي؟ …
ـ يتبع ـ


ويستمر النزيف… آلاف الأطباء والمهندسين والجامعيين يغادرون تونس

وفاة الفنان صلاح السعدني… وداعا سليمان غانم!

الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس

بن غفير يصف الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ”الضعيف”

بعد اعتراضها على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة… ماذا تريد واشنطن؟
استطلاع

صن نار

 اجتماعياقبل 11 ساعة
اجتماعياقبل 11 ساعةويستمر النزيف… آلاف الأطباء والمهندسين والجامعيين يغادرون تونس

 ثقافياقبل 11 ساعة
ثقافياقبل 11 ساعةوفاة الفنان صلاح السعدني… وداعا سليمان غانم!

 صن نارقبل 11 ساعة
صن نارقبل 11 ساعةالاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس

 عربيا دولياقبل 11 ساعة
عربيا دولياقبل 11 ساعةبن غفير يصف الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ”الضعيف”

 صن نارقبل 12 ساعة
صن نارقبل 12 ساعةبعد اعتراضها على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة… ماذا تريد واشنطن؟

 صن نارقبل 12 ساعة
صن نارقبل 12 ساعةطهران… مفاعل ديمونا ليس من ضمن أهدافنا!

 صن نارقبل 12 ساعة
صن نارقبل 12 ساعةاستمرار الهجمات المتبادلة بين الكيان وإيران… وقصف أصفهان

 من يوميات دوجة و مجيدةقبل 22 ساعة
من يوميات دوجة و مجيدةقبل 22 ساعةحميدة في ساتت كرش
