جور نار
ما يُمكن أن يُقال …في مفتتح سنة أخرى للنجاح ومراكمة المعارف
نشرت
قبل سنتينفي
من قبل
منصف الخميري Moncef Khemiri
“مساعدة مبالغ فيها يمكن أن تؤدّي إلى الحلول محلّ أبنائكم حتى تجدوا أنفسكم تقومون بالواجبات المدرسية اليومية عِوضًا عنهم، ولكن مساعدة باهتة أو منقوصة أو منعدمة يمكن أن تُبقيهم سجناء صعوباتهم وفاقدين للقدرة على اللّحاق بقطار التعلمات السريع.”

قصّة الطفل لويس مهمّة، لكنها بحاجة إلى التنسيب :
طفل فرنسي يُدعى لويس كان لا يحب المدرسة وتميّز دائما بكونه خجولا وميّالا إلى العزلة ولا يتمتّع بأية سيولة في الكلام وأداء السّلام. كان لا يحب اللغة الفرنسية ولا مادة الرياضيات. عائلته الميسورة اجتماعيا “دخلتها غولة” لأن لويس سيكون في أسفل السلّم العائلي، خاصة أن شقيقه الأكبر زاول تعلمه العالي الهندسي بشكل متميز وأصبح يمثل مفخرة العائلة وحامل لوائها ؟ ظنّت عائلته في البداية أنه ضحية المقارنة بأخيه، لا شيء من هذا لأن لويس لا تعنيه المقارنات والنياشين المدرسية. خيّر في سنّ مبكّرة أن يُهيّئ لنفسه ما يُشبه الورشة الصغيرة في زاوية من منزلهم العائلي يفكّك فيها ويركّب ويتأمّل ويُجرّب… وعوض الذهاب إلى المدرسة اختار لويس أن يكون عاملا متربّصا في معامل سربولي للميكانيك الشهيرة.
هو لويس رينو Louis Renault الذي قدّم أول براءة اختراع وعمره لم يتجاوز 22 سنة وستتلوها 500 براءة أخرى … حتى أصبح على مرّ السنوات على رأس إمبراطورية لصنع السيارات ومحركات الطائرات والمدافع الحربية. لكن اسمه شاع خاصة بفضل سيّارات رينو التي غزت العالم بأسره.
وهو الذي قال سنة 1934 أمام التطوّر الهائل في شركة أندريه سيتروين “أنا سعيد جدا بأن يكون السيد سيتروين منافسا لي، لأنه يدفعك للعمل ويُجبرك على المُصارعة”.
هذا يعني أن لويس كان قادرا على “التعلّم” وبشكل جيّد … في 1908 حين كان العالم خاليا من الكتب والأدلّة المتخصّصة ووسائل الاتصال الحديثة واليوتيوب والهاتف المحمول … كانت طريقا وعرة وشاقّة جدا تنعدم فيها الإنجادات والمساعدات وتتكدّس فيها أطنان من المصاعب والتضييقات، إذ كان عليه أن يتعلم لوحده قوانين علم الميكانيكا ومبادئ التصرف والمحاسبة وإدارة الأعمال وقواعد اللغة الفرنسية وأساليب الرّسم والتصميم الفنّييْن (دون مساعدة الحاسوب كما هو الشأن اليوم).
المدرسة لم تكن بالنسبة الى لويس رينو السياق الأمثل لتعلّم ما كان مهووسا به ومُدركا أن فهمه للنجاح غير فهم المدرسة له وأن الذي كان يشغل ذهنه باستمرار لم يكن مشغل المدرسة التي تردّد عليها لبضع سنوات. كان في حاجة إلى مربّع تعلّمي مختلف لكوْنه كان مختلفا. وكانت قوّته الأساسية تكمن في أنه اكتشف ذلك مُبكّرا وتجنّب بالتالي الوقوع في فخّ ” أعدادي ضعيفة ولم استطع التعلّم وفق انتظارات المدرسة والمدرّسين، إذن أنا سيّء وفاشل”. وهو نمط سلبي للتفكير غالبا ما تعتمده شريحة واسعة من التلاميذ الذين يعانون من صعوبات مدرسية مُعيقة ومهدّدون بالانقطاع في أية لحظة.

هذا لا يعني بطبيعة الحال أن المدرسة لا لزوم لها، وإنما ذلك يعني :
___ أن لكلّ واحد طريقته في التعلّم، لكن المدرسة بصورة عامة مازالت متشبثة بفلسفة للتربية تَنشُد عرْضا مُوحّدا ومنهجا موحّدا ونموذج نجاح موحّدا للجميع… فيتأقلم البعض ويتعبُ البعض الآخر حتى يتأقلم، وينسحب جزء آخر عدده غير قليل لأنه استحال عليه التأقلم.
___ أن المدرسة أفضل ما اكتشفته الانسانية إلى حدّ اليوم من أجل “تعليم المبادئ الأساسية للحياة الأخلاقية ونشر العلوم والمعارف” كما يقول المؤسّسون، لكنها في نفس الوقت إذا كانت إطارا جيدا وملائما بالنسبة إلى البعض من الذين نجحوا في التماهي مع متطلبات المدرسة واشتراطاتها، فهي ليست بالضرورة كذلك بالنسبة إلى البعض الآخر من الذين يرتبط القِسم في أذهانهم بالضّجر والملل وإضاعة الوقت.
وعليه، فإن المستقبل لن يكون لتدمير المدرسة وتجاوزها والادّعاء أن “اليوتيوب” أصبح أفضل مدرّس في العالم، وإنما على المدرسة أن تُغيّر فلسفتها للتربية وتُجهِد نفسها بدلا من إجهاد الآخرين وتحاول التكيّف مع خصوصيات الأفراد الذين يؤمّونها بدلا من إجبار المتعلّمين على “تكيّف” هم غير قادرين عليه.
ولها في لويس رينو وريتشارد برونسون (مؤسس شركة فيرجين) وستيف جوبس (مؤسس العملاق آبل) وغيرهم… أمثلة لتلاميذ على قدر استثنائي من الذكاء والنّبوغ استبعدتهم المدرسة بــ “غبائها” وحكمت عليهم بالفشل ومسالك الانحراف المختلفة… لولا بعض الإصرار الذاتي والقدرة الفائقة لديهم ولدى أوليائهم على تحييد أصوات الإحباط وإبطال مفعولها.
ويبقى السؤال جاثما على صدور جميع المهتمّين بمثل هذه المفارقات المدرسية : بأية وتيرة وأي انتظام وأي تواتر تَقدر المجتمعات على إنجاب نوابغ وذكاءات و”فلتات” تستطيع تحدّي المدرسة التقليدية/المعاصرة وانتهاج “السُّبل البِكر” كما يقول محمود المسعدي لإحراز النجاح والتفرّد ؟ وما هو العدد التقريبي لمن يستطيعون النجاح دون شهائد ؟ وما هي نسبة العلماء والمكتشِفين وروّاد الأعمال والرياضيين العالميّين الذين تألّقوا خارج أسوار المدارس والجامعات من مجموع ملايين المتعلّمين ؟
النسبة ضئيلة جدا بكل تأكيد والواقع يؤكّد العكس تماما، أي أن نسبة الذين يرتقون اجتماعيا بفضل المدرسة أكبر بكثير من الذين يرتقون بدونها. زد على ذلك أن أغلب الذين قاطعوا التعليم التقليدي ونجحوا كان لديهم ما يُعوّض بشكل قوي على غياب المدرسة : إمّا ذكاء وقّاد ومهارة استثنائية في مجال مخصوص أو مسالك تكوينيّة غير تقليدية أو عائلة عارفة جيدا كيف تُصقل المواهب وتُنمّى المهارات (عالم الرياضيات والفيزيائي آمبير مُكتشف التليغراف الكهربائي كان والده مصرّا على تعليمه بنفسه، وبيار كوري صاحب جائزة نوبل في الفيزياء كانا والداه ثم صديق للعائلة وراء صعوده…)
فأي درس يمكن استنتاجه من خلال كل هذا في سياقنا التربوي التونسي ؟
في مجال التربية والتعليم بالذات، لا يمكن الادّعاء ـ دون السّقوط المُدوّي في أتون التنمية البشرية- بأن هنالك وصفات جاهزة للنجاح ومناويل أفضل من أخرى لتأسيس مدرسة خالية من العيوب وقادرة على إنجاح كل مرتاديها… ولكن بعد هذه المسيرة الطويلة لتجربة المدرسة العمومية والإلزامية وفي علاقة بما كنّا بصدده أعلاه، يمكن الاحتفاظ بالفكرة التالية :
غالبا ما يُبالغ المجتمع في مطالبة الأطفال والشباب بالعمل والتصرف والتفكير بشكل ينسجم تماما مع ما تطلبه المدرسة، ولا يُلحّ كثيرا في مطالبة هذه الأخيرة بتغيير أساليبها ومقارباتها حتى تنسجم تماما مع انتظارات وحاجيات كل المتعلّمين باختلافاتهم وتنوّعهم. وانطلاقا من هذا، يمكن القول إنه لا يجب أن تكون المدرسة “فضاءً نموذجيا للمتفوّقين” ولا “مجرد منطقة عبور للناشئة يُحصّلون فيه ما (كْتِبْ من ربّي)” وإنما عليها أن تتحوّل إلى حقل واسع تُزهر في تُربته جميع النباتات ـ كلّ حسب حاجاتها وخصوصيّتها-ـ ولا يُترك فيه أحد على حافّة الطريق.
تصفح أيضا
جور نار
“زيدها شويّة”… أو كيف نُواجه سعير الأرقام في تونس
(من خلال أمثلة حيّة)
نشرت
قبل 23 ساعةفي
15 أبريل 2024من قبل
منصف الخميري Moncef Khemiri
ذكّرني التغيير الذي حصل مؤخّرا على رأس المعهد الوطني للإحصاء (احتمالا على خلفية دكتاتورية الأرقام التي لا تُجامل ولا تُعادي) بجملة من الأحداث والوقائع التي عشتُها شخصيا في أكثر من موقع والمُثبِّتة لعقليةٍ تشكّلت في بلادنا منذ العهود السابقة.

مفادُ هذه العقلية كسْر المحرار إذا باح بنتائج لا تتطابق مع انتظارات المسؤول السياسي، والهروب بصناديق الاقتراع عندما كان يتوقع طلبة التجمع الحاكم عدم الفوز في انتخابات المجالس العلمية كما كان يحصل في الجامعة التونسية… وعقلية “زيدها شوية” هذه نجد لها أثرا أيضا في نسيج العلاقات الأسرية وفي تعاطي عموم الناس مع الظواهر المختلفة وتفاصيل حياتهم اليومية، لأن الترقيع في ثقافتنا أعلى صوتا دائما من المعالجة الجذرية لمصادر أوجاعنا، وآليات والتسكين والتخفيف والتليين والتقليل والتمسكين منوالٌ قائم بذاته في رُبوعنا.
فعلى سبيل المثال عندما يُنتهك حقّ البنت في الميراث، لا يُجمِعُ أغلب الناس على إرجاع الحق إلى أصحابه بل يجنحون إلى المحافظة على الوضع القائم مع إضافة جملة ترقيعية “زيدها شوية ووخيّان كيف آمس كيف اليوم” … وعندما تعوجّ حيطان البنّائين المُبتدئين تجد دائما من يحاول التنسيب بشكل ماكر “ثمة شوية عوَج صحيح آما توة باللّيقة تتسوى” … وعندما يعجز بعض الأطباء عن تشخيص مرض ما بدقّة، يسقطون في ما يُشبه تقليعات التنمية البشرية “والله ما عندك شيْ، المشكل الكل في راسك، عندك برشة هلواس. آقف قدام المراية وصيح مانيش مريض توة ترتاح”…
المثال الأول : نسب النجاح في السنة الأولى بكلية العلوم
في بداية الألفية الجديدة، طلب المسؤول الأول عن مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة التابع للديوان بوزارة التعليم العالي، من رئيس مصلحة متابعة النتائج الجامعية (السيد ت.ع وهو من روى لي تفاصيل الحادثة) مدّه بنتائج آخر السنة الجامعية بالنسبة إلى كلية العلوم بتونس، فلمّا لاحظ أن نسبة النجاح العامة (في كل الاختصاصات مجتمعة) تراجعت خلال ذلك العام من 33 إلى 27 % أشعل سيجارة وسحب منها نفسا عميقا كمن يبحث عمّا يُساعده على ابتلاع نسبة التراجع التي سيُسأل عنها أمام وزيره آنذاك…ثم قال له في شبه توسّل “لا شويّة بالكل سامحني سي فلان، من رايي تزيدها شوية”.
المثال الثاني : في نفس الوزارة
في 2007، عندما انطلق تطبيق منظومة إمد على مراحل وكانت شهادة الأستاذية ماتزال قائمة جزئيا ريثما تحلّ محلّها شهادة الإجازة، طلب الوزير من المدير العام للشؤون الطالبية مدّه بإحصائيات حول مدى إقبال التلاميذ الناجحين الجدد في الباكالوريا على الإجازات الجديدة مقارنة بإقبالهم على الأستاذيات. ولمّا كانت النتائج الأوّلية مؤكدة لتوجّه الناجحين في الباكالوريا أغلبيّا نحو اختيار شهادة الأستاذية بدلا من الإجازة الجديدة، وبالتالي مُخيّبة لآمال من كان يتوقّع أن “إصلاح إمد” سيُعطي أُكله مباشرة بعد الشروع في إنفاذه بما يبرّر وجاهة الاختيار وسلامته، تمّ التشكيك في سلامة الأرقام فأعيد الاحتساب من جديد لتستقر نتائجه على نفس ما عبّر عنه المسح الأوّل، فلم تبق لديهم أية ذريعة سوى تسجيل ذلك على حساب ضعف الإعلام وجهل الأغلبية الساحقة من الأولياء بمزايا النظام الجديد… “وعلى أية حال توة نزيدوها شوية نسبة الإقبال على الإجازات في التدخلات الإعلامية دون تقديم أرقام دقيقة حول المسألة” … كانت هذه هي الفتوى التي أوجدوها للخروج من المأزق.
المثال الثالث : مشاركة التلاميذ التونسيين في تقييم “بيزا” الدولي
كانت تونس من أولى الدول العربية التي تشارك في البرنامج الدولي لتقييم الطلاب “بيزا”، وذلك منذ سنة 2003، وهو تقييم دولي لقيس قدرة الطلاب في سن 15 عامًا (أي نهاية السنة التاسعة أساسي لدينا) على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية كل 3 سنوات. سنة 2015 احتلت تونس المرتبة 65 على 70 دولة مشاركة في الاختبارات (رتبة تقاسمتها تونس مع لبنان ضمن هذا التقييم الذي شمل عيّنة من 540 ألف تلميذ من مختلف أنحاء العالم).
وبدلا من مُواجهة الأسباب العميقة التي أدّت إلى تصنيف تلاميذنا التونسيين في ذيل الترتيب العالمي وهو مؤشر تُنكّس له الأعلام الوطنية لأنه يعكس وضع الوهن الموجع الذي باتت عليه منظومتنا التربوية، اختارت دولتنا أن تُقاطع هذه المحطة التقييمية الكونية مُفرغةً المحرار من زئبقه وضخّه ضمن خطابها الرسمي القائل بأن المؤشرات التي ينبني عليها التقييم صُنعت على مقاس التلميذ الأوروبي والسنغافوري والياباني وليس على مقاس التلميذ التونسي الذي يدرس ضمن بيئة خصوصية ووفق برامج ومناهج خصوصية !
المثال الرابع : 0.4 نسبة نموّ ليست من شِيمنا
دوّن المؤرّخ الجامعي نورالدين الدڨي على صفحته الرسمية يوم 23 مارس ما يلي :
“المعلوم أن المعهد الوطني للإحصاء لا يستنبط الأرقام؛ وليس مطلوبا منه تزويقها؛ فمهمته حسب نصوصه الـتأسيسية : “جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالبلاد و معالجتها و تحليلها و نشرها بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى”، وما نشره المعهد مؤخرا عن نسبة النمو الاقتصادي بتونس لسنة 2023 التي حددها ب 4 .0 بالمائة، وعن نسب البطالة : 4 .16 بالمائة، هو انعكاس أمين لقدرات الجهاز الإنتاجي الوطني…”
لكن وكما أسلفنا بالنسبة إلى الأمثلة السابقة، بدلا من مُعالجةٍ رصينة ومتأنية للأسباب الحقيقية والعميقة التي أدّت إلى هذه النتائج الموضوعية، تمّ اللجوء إلى إجراء تحوير على رأس هذه المؤسسة الوطنية ذات الطابع التقني والخِبري الصرف التي ظلّت علاقتها بصاحب القرار السياسي على مرّ السنوات منذ تأسيسها سنة 1969 مُتأرجحة بين نشر الأرقام كما هي أو في أسوإ الأحوال التعتيم عليها وعدم الإدلاء بها قصد التداول العام ولكن (وحسب شهادة عديد الكفاءات التي مرّت بنهج الشّام وتعمل اليوم بمؤسسات دولية وإقليمية مرموقة) لم يحدث أن تمّ تزوير الأرقام أو التلاعب بها.
أستعيد في النهاية ما قاله أحد المفكّرين “يمكنك أن تراوغ رجال الشرطة لكنه من الصعب جدا مراوغة بداهة الإحصائيات”.

.
عبد القادر المقري:
لي شبه يقين أن مسلسلاتنا التونسية (تماما كسينمائنا) محظوظة حظا يكسر الحجر كما يقال … فهي أقرب ما تكون إلى تلاميذ ذات فترة من عمر وزارة التربية، وهي تجربة المقاربة بالكفايات … لا أحد يأخذ صفرا، لا أحد يسقط في امتحان، لا أحد يعيد عامه، ولا أحد يتم طرده لضعف النتائج …

بل لا قياس أساسا لأي جهد … الكل ناجح، والكل ممتاز، والكل متفوق، والكل نابغة بني ذبيان … والدليل أننا عند نهاية مهرجان من مهرجاناتنا أو عرض فيلم من أفلامنا، لا تسمع سوى الشكر، ولا تقرأ سوى المدح، و لا ترى سوى الحمد على نعمة السينما والذين أدخلوها إلى تونس … تماما كما يحصل عقب كل رمضان مع أعمالنا الدرامية، إن وُجدت … فدائما عندك جوائز لأحسن عمل، وأفضل مخرج، وأبرع ممثل، و أقوى سيناريو، وأكبر وأجمل وأبهى وأمتع وأروع … يا دين الزكش، كما يقول صديقي سلامة حجازي … يعني كل بلاد العالم (بما فيها هوليوود وبوليوود وقاهرة وود ودمشق وود) تنجح فيها أعمال وتفشل أعمال، إلا عندنا فيبدو أننا الفرقة الناجية …
… أو فرقة ناجي عطا الله !
هذه السنة، أتاح لي زميل مسؤول بإحدى الإذاعات أن أتفرج على قسم كبير من مسلسلين تونسيين مرة واحدة… قلت أتاح لي بعد أن رجاني مشكورا أن أدلي برأيي في هذا وذاك، وأنا اليائس منذ أعوام من مستوى مسلسلاتنا خاصة حين جنح معظمها إلى تقليد عمل أعتبره كارثة فنية بكل المقاييس، وهو مسلسل “مكتوب” … وصار الكل يستنسخ منه استنساخ أهل الغناء والمسرح لعرضي النوبة والحضرة طوال الثلاثين سنة الأخيرة … وكيف لا يفعلون وهم وجدوا الوصفة السهلة التي لا تكلّف تعبا ولا وجع رأس … فمثلما بإمكانك أنجاز “عرض” فني لا نص فيه ولا فكرة مبتكرة بل تكديس جملة من أغاني التراث وإلصاق بعضها ببعض، بإمكان الواحد أن “يبيض” مسلسلا لا قصة فيه ولا حوار ولا سيناريو… فقط عندك ركام من عارضي وعارضات الأزياء، يقولون في ما بينهم كلاما من الحزام فما أدنى منه، ويعيشون في بذخ لا تحلم به أميرة خليجية، ويستبيحون القوانين أصغرها وأكبرها، ولا قيم توقفهم ولا منطق ولا نواميس مجتمع … عكعك وهي حالّة معك، كما يردد شباب هذه الأيام …
إذن أخذا بخاطر صديقي، تفرجت صاغرا في اثنين من أعمالنا المعروضة لرمضان هذا العام، قائلا لعل الأمور تحسنت عمّا تركتها، وربما ظلمت مبدعينا الفتيان وهم يفتحون البلدان ويغزون الفضاء في غفلة مني … وبما أن ذلك فاتني على المباشر، فقد لجأت إلى التساجيل التي تبث على الإنترنت، وأطوي الأرض طيا حتى أرى أكثر ما يمكن ولا أتسرع في الحكم على أحد … رأيت إذن جزءا كبيرا من مسلسل “فلوجة 2” على الحوار التونسي، وجزءا مماثلا من “رقوج 1” (بما أنهم يبرمجون لجزء ثان على ما سمعت) … وأعطيت رأيي في حدود ما شاهدت، وواصلت بعد ذلك باقي الحلقات حتى تكتمل الفكرة وأكون بدوري من المحتفلين ختاما بأفضل عمل وممثلين ومخرجين إلى آخر الليستة … وعلى حق …
نبدأ بفلّوجة … هو أولا استمرار لقصة السنة الماضية التي أثارت أكثر من ضجة لدى رجال التعليم ونسائه … والسبب أن احداث المسلسل تدور في وحوالي معهد ثانوي فيه كل شيء إلا الدراسة … مخدرات في قارعة الطريق، علاقات جنسية بوها كلب بين الجميع والجميع، ولادات خارج إطار الزواج وغير ذلك … والعجيب أن احتجاج المربين قابلته عاصفة تبريرية كانت دائما السند الرئيسي لسامي الفهري ومسلسلاته … من نوع: أليس هذا واقعنا؟ ألا تحدث يوميا مثل هذه الفضائح؟ هل ما زال عندنا تعليم؟ ألم يهبط مستوى مؤسساتنا التربوية منذ زمن؟ هل نغطي عين الشمس بالغربال؟ أما كفاكم نفاقا؟؟ … ويصل التبرير إلى ذروته بالتهجم على الأساتذة أنفسهم … “ماهي جرايركم” … “ما هو من جرة” انغماسكم في الدروس الخصوصية وإهمالكم لعملكم الأصلي … “ماهي نقاباتكم” وإضراباتكم ومطالبكم وزياداتكم المتلاحقة، وبسببها أفلست المعاهد وصارت بؤرا فاسدة، فيما هرب الجميع إلى التعليم الخاص… وغير ذلك وغير ذلك …
ولم يقل أحد من هؤلاء لسامي الفهري: وأنت، ما غايتك من الترويج لهذه المظاهر؟
وبقطع النظر عن صحة كل هذا في المطلق، والإحصائيات التي ما زالت لصالح التعليم العمومي في الباكالوريا وغيرها مهما حصل … فإن هذا التعميم يظلم كثيرا من أهل التعليم الأوفياء وجهدهم في إنجاح تلاميذهم وتمكينهم من مستوى جيد دون مقابل عدا مرتب شهري بعرق الجبين … كما يحط هذا التقييم الشمولي من قدر أبنائنا وبناتنا المربين والمربيات الأشراف وأغلبهم يتمسك بفضائلنا وأخلاقنا … فهل كل أساتذتنا متحرشون بتلميذاتهم كما في المسلسل، وهل كل أستاذاتنا ومديرات معاهدنا شغلهن الشاغل إقامة علاقات جنسية مع هذا التلميذ أو ذاك الرجل العابر؟ …
وحتى إن حصلت بعض حالات فماذا تمثل نسبتها؟ 1 بالمائة؟ اثنان؟ ثلاثة بالمائة ولا أعتقد ذلك وسط مئات آلاف من منظوري وزارة التربية … ومن يقول أكثر عليه بإجبار الوزارة على التحقيق العاجل ويكون معها فيه، ثم أين منظمات الأولياء والتربية والأسرة؟ لو كانت معاهدنا على شاكلة معهد سامي الفهري، فمن الأحرى غلق مؤسساتنا التعليمية وإحالة ميزانية الوزارة نحو قطاعات أكثر احتياجا كالشؤون الاجتماعية أو الثقافة أوالفلاحة والصيد البحري … بل ربما نضع كل ما نملك بين يدي الأمن والقضاء حتى يقضيا القضاء المبرم على الداء الذي استفحل ويهدد بنسفنا من الجذور …
فلوجة في جرئه الثاني لم يشذ عنه في الجزء الأول … لا بل هو يستمر في شذوذه الآخر … عن كل ما هو مجتمع وأعراف وقيم ولنقُلْ أيضا، مسؤولية … فالعمل الدرامي ليس مجرد نقل للواقع (هذا إذا كان واقعا) بل فيه طرح ورسالة وتأثير مباشر خاصة مع طغيان الصورة ووسائل الاتصال الحديثة … الفهري ومرؤوسته سوسن الجمني، يتملّحان طولا وعرضا بما يمكن أن ينتج في مجتمعنا من تغيير سلوكات جراء ما يعرضانه في كل مسلسل …
ـ يتبع ـ


لم تكن التهديدات من هذا الطرف او ذاك توحي بخطر شن حرب بين إيران و اسرائيل، ذلك ان طهران كانت عمليا تتفادى مواجهة مباشرة مع اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة وتعي بان الكيان اللقيط لا يعدو أن يكون إحدى ثكنات القوة الأعظم.

و لم يتهور الايرانيون المعروف عنهم العمل بصمت و عقلانية و تقبل بعض الخسائر المفترضة و المنتظرة مقابل تنويع مواطىء اقدامهم و تركيز مواقع قد تخدمهم لاحقا دون أي تسرع عاطفي ممثل في رد فعل غير محسوب الهدف او النتائج … لقد دفعت إيران قرابين كثيرة منذ التسعينات ضحايا لاغتيالات الموساد و المخابرات الأمريكية المتعاونة من تفجير مراكز نووية إلى اغتيال علماء او قيادات عسكرية هامة و الظاهر ان الإيرانيين يرسمون أهدافهم الاستراتيجية على المدى الطويل والتي يعتبرونها اهم بكثير من صراعهم مع الكيان الصهيوني… وقد نجحت لحد الان السياسة الإيرانية في تركيز اذرع في عدد من البلدان العربية ذات مكانة استراتيجية هامة مثل سوريا و العراق ولبنان و اليمن، وهي ساعية اليوم لغرس امتداد لها بالأردن، كما عمدت خلال هذه الأسابيع إلى دعم حكومة السودان ومدها بالطائرات المسيرة التي قلبت موازين المعارك ضد قوى الدعم السريع.
لكن الحدث الذي جد اخيرا و الذي تمثل في ضرب الصهاينة للقنصلية الإيرانية بسوريا والقضاء على واحد من اكبر القيادات الحربية و التنسيقية قد يؤجج ما كان كامنا بين الكيان وطهران. فإسرائيل ترغب منذ سنوات في توريط حلفائها الأمريكان في حرب ضد إيران وقد تراءت لنتنياهو فرصة سانحة للدفع نحو هذه الحرب المرغوب فيها اولا و لتمديد بقائه في الحكم و إتمام خططه النازية من تهجير و مجازر و تدمير لغزة و لاحقا للضفة الغربية، وهنا لم يبق لإيران بد من رد فعل قوي لحفظ ماء الوجه و تأديب الكيان الذي تجاوز الخطوط الحمراء و ضرب القنصلية الإيرانية التي تمثل سيادتها و صورة قوتها أمام الجميع وخاصة لدى اذرعها وأنصارها في المنطقة.
ومنذ ساعات أعلنت المخابرات الروسية عن تحديد ضربات او حرب خاطفة ممكنة الوقوع قريبا جدا و دعت مواطنيها لملازمة الحذر بالشرق الأوسط وخاصة بالكيان الصهيوني و منذ اكثر من ساعة دعت الولايات المتحدة مواطنيها في الأرض المحتلة وتل أبيب خاصة الى نفس الحذر. اذن فالوضع قابل جدا لوقوع حدث هام مدمر ليس باسرائيل فقط لكن أيضا بايران اعتمادا على ان الكيان الصهيوني يرغب فعليا في خلق مواجهة مع ظهران ستقودها الولايات المتحدة دون شك.
هل ستصدر الضربة الإيرانية انطلاقا من قاعدة احد اذرعها؟ هل سيكون الهدف محطة ديمونة النووية او ايلات او تل ابيب؟ اظن ان ضرب تل أبيب مستبعد مما يبعث على الظن بان الهدف المحتمل هو: إما إحدى السفارات الاسرائيلية في بلد خليجي او قصف إحدى المدن او المطارات الكبرى بالكيان الصهيوني. فيما يبدو أن الولايات المتحدة لا ترغب حاليا في خلق بؤرة حرب جديدة مكلفة قبل انتخابات نوفمبر القادم و لن تصل اية ضربة مهما كانت صدمتها إلى دفع بايدن إلى رد فعل ضد إيران …

استطلاع

صن نار

 اقتصادياقبل 6 ساعات
اقتصادياقبل 6 ساعاتتأجيل النظر في بيع المعامل الآلية بالساحل
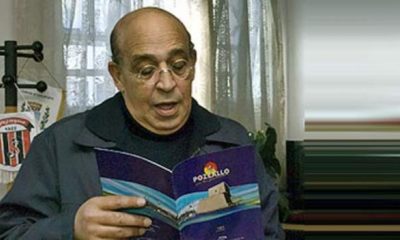
 اجتماعياقبل 8 ساعات
اجتماعياقبل 8 ساعاتوأخيرا… البدء في محاسبة قاتلي الجيلاني الدبوسي

 رياضياقبل 13 ساعة
رياضياقبل 13 ساعةماكرون يدعو النقابات إلى “هدنة أولمبية”

 صن نارقبل 13 ساعة
صن نارقبل 13 ساعةقمر صناعي ثان لكوريا الشمالية

 اجتماعياقبل 13 ساعة
اجتماعياقبل 13 ساعة“مهاجم سيدني”… هل استهدف النساء دون الرجال؟

 صن نارقبل 13 ساعة
صن نارقبل 13 ساعةعودة المستوطنين إلى اجتياح حي الشيخ جراح

 صن نارقبل 13 ساعة
صن نارقبل 13 ساعةرغم هجوم السبت على تل أبيب… أمريكا لا ترغب في حرب مع إيران!

 صن نارقبل 13 ساعة
صن نارقبل 13 ساعةالأردن… لن نقطع العلاقات مع الكيان!
